
كلمة فضيلة الشيخ مالك وهبي (أستاذ في الحوزة العلمية): القوامة في الإسلام: سلطة أم ضرورة اجتماعيّة لحماية المرأة والأسرة؟
القوامة في الإسلام: سلطة أم ضرورة اجتماعيّة لحماية المرأة والأسرة؟
كلمة فضيلة الشيخ مالك وهبي (أستاذ في الحوزة العلمية)
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحوا لي أنّ لا أتحدث كثيراً عن هذا العنوان، لأنّي رأيت خلال كتابة بحثي الحاجة الماسة إلى ذكر أفكار تمهيدية ضرورية لفهم حقيقة قوامة الرجل على المرأة، ولن يتاح لي وفق ما سأعرضه ووفق الوقت المتاح الدخول كثيراً في عنوان البحث:
الّذي أريد قوله من أفكار تمهيديّة مع كلام مختصر حول العنوان، يمكن تلخيصه بالنقاط التاليّة:
1) الإسلام خاتم الأديان فلا دين بعده، وهو دين شامل لكل مناحي الحياة فلا بد أن يتضمن نظاماً كاملاً في الحياة يمكنه أنّ يستمر أبد الدهور فلا نحتاج بعده إلى دين آخر, نعم لا بد من مواكبة كل زمان ومكان بهاد يعرف الحقيقة الكاملة عن الدين بأصوله وفروعه كلها، لذا فإنّ كثيراً منّ المشاكل التّي نعانيها هي بسبب بعدنا عن ذلك الهادي أعني مولانا صاحب العصر والزمان.
لا يمكن البحث في مفردة من قضيّة ترتبط بنظام كامل دون أن نضع تلك المفردة في سياقها الطبيعي ضمن تلك المنظومة. وفي الحقيقة هنا منظومتان كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي منظومة الدين ككل فهو نظام حياة له أصول وفروع تتكامل فيما بينها لتشكل ذلك النظام، فلا ينفك فرع عن فرع بل تنشد وتنجذب إلى الجامع بينها ليجعل كل فرع منسجما مع الآخر، وأي تفكيك بين الفروع سواء فيما بينها أو تفكيكها عن الجامع يؤدي أحياناً إلى ضياع تلك الفروع.
2) المنظومة الكبرى تشتمل على أحكام تنظم الحياة بكل أبعادها وفي كل علاقاتها الاجتماعية الكبرى والأسرية بما تتضمن من علاقات الأرحام والأسرية الخاصة التي ترتبط بالبيت العائلي أي الزوجين والأولاد. هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما هو متسالم عليه بين فقهائنا سواء فهمنا تلك المصالح والمفاسد وأدركناها أم لا، لكنا بالتأكيد نعلم أنّ تلك الأحكام نبعت منها، لذا يسميها فقهاؤنا بملاكات الأحكام، فكل حكم ينبع من ملاك في متعلقه وإرادة شرّعته.
والمنظومة الصغرى هي النظام الأسري الخاص وأحكامه وقوانينه التي يجب أنّ يلحظها كوحدة متكاملة لا كأحكام متفرقة، فما ضاع النظام الأسري إلا بعد أنّ كان النظر إلى أحكامه على أنّها أحكام مفككة منفصلة متفرقة لا جامع بينها لا على مستوى الحكم والمصالح ولا على مستوى إرادة الله سبحانه وتعالى. وسيكون لهذا التفكيك تأثير يؤدي إلى ضياع منظومة الدين ككل إن نظرنا إلى مجموعة أحكامه نظرة تفكيكيّة وإلا كيف يمكن اعتبار الدين نظام حياة إنّ لم يكن لهذا النظام نحو ترابط يؤثر بعضه على بعضه الآخر، وجامع ترجع إليه كل أحكامه لتؤطرها في نظام واحد.
3) ولعل هذا من الجهد غير المبذول حتّى الآن كما ينبغي أنّ يبذل، وهو تقديم أحكامنا الفقهيّة الشرعيّة المرتبطة بالجانب الحقوقي والمعاملي في إطار منظومة متكاملة نجد بعض الجهد على مستوى تشكيل منظومة العقود والمعاملات التجارية ومع ذلك فالجهد غير تام. ونجد بعض الجهد في بيان منظومة قضائيّة ومع ذلك فالجهد غير تام والجهد أضعف فيما يتعلق بأبواب الزواج والطلاق بما يرتبط ببيان حق كل طرف في هذه الأبواب من رجل وامرأة وولد، وبما يرتبط بالمنظومة الحقوقيّة في الإسلام بكل إنسان قبل أنّ ننظر إليه كزوج أو زوجة أو أب أو أم أو ابن أو أي عنوان آخر.
فرب حق نسلبه عن أحد بمنظار ما، لكننا قد نغير رأينا لو وضعناه في إطاره الصحيح واتضحت لنا أسسه. ورب حق نثبته لأحد ما قد نغير رأينا فيه لو وضعناه في ذات الإطار. لا يعني تغيير رأينا إثبات ما سلبنا أو سلب ما أثبتنا بل ربما يؤدي إلى تقنينه وجعل ضوابط تجعله ثابتاً تارةً ومنفياً تارةً أخرى حسب الشروط والقيود التّي ينتجها لنا الإطار العام الجامع. فالمنظومة المذكورة تسهل لنا القبول بحق وإنكار حق، وتعيننا على نفي حق ربما توهمنا ثبوته أو إثبات ما توهمنا نفيه.
تلك المنظومة لو وجدت ربما ستغير نظرتنا للأمور فلا نرى حكماً كأنه يلغي حكماً آخر في الوقت الذي يجب أنّ يتكاملا فيه. هذه النظرة توجبها النظرة التجزيئيّة للأحكام التّي لا حل لها إلا بالنظرة العامة الشاملة التي تؤلف المختلفات.
4) في هذا النظام الشامل تأخذ الأخلاق حيزاً مهما تدخل في مبادئ الأحكام التّي يتم تفريعها، فتكون عنصراً مهماً من عناصر المواءمة بين الأحكام. فليس صحيحاً أنّ الأخلاق تدخل في باب الآداب والمستحبات والمكروهات، بل كثير منها يدخل في باب الواجبات والمحرمات بل في الأساسيات، أليس حسن العدل وقبح الظلم ركن يعلو فوق كل الأحكام؟ طبعاً لا نطلق كلاماً شاعرياً فالقضية أي حسن العدل وقبح الظلم لها ضوابطها التّي اشتغل عليها علماؤنا، وليست مجرد استحسان من هنا أو استبعاد من هناك. فالقضية بتلك الدّقة التّي اشتغل عليها علماؤنا أدرجوا في قضايا العقل التّي اعتبروها أولى الأوليات التشريعية، ومع ذلك حين التطبيق ينظر إليها على أنها أمر أخلاقي يدخل في الآداب العامة.
كم من حكم ربما يتغير وفق تلك المنظومة، ولهذا شواهد. فلا يقام حد مثلاً على مستحق في أرض العدو.
مبدأ حسن العدل وقبح الظلم من المبادئ التي لا تقبل التخصيص، وكل علمائنا يعترفون أنّ العدل حسن على كل حال فليس له حالتان حالة حسنة وحالة قبيحة، لكن يجب العمل على تأسيس المفهوم الصحيح للعدل. ويقولون أنّ الظلم قبيح دائماً فليس له حالتان قبيح وحسن، لكن بنفس الشرط أي تأسيس المفهوم تأسيساً صحيحاً. فإن رأينا حكماً يتنافى مع هذا المبدأ وجب تقييده لأن المبدأ غير قابل للتقييد.
5) كثيراً ما يكون للنظرة المسبقة في المعتقدات وصفات الله تعالى وصفات المعصومين(ع) والأخلاق أثر مهم في فهم كثير من الروايات وتاريخ الأئمة والأنبياء عليهم السلام وأفعالهم. فعلى سبيل المثال: يتناقش العلماء في جواز بيع العنب لمن يعمله خمراً. وقد وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام تدل على جوازه بل في بعضها أنهم عليهم السلام يفعلون ذلك.
ذهب الإمام الخميني(قده) إلى عدم جوازه رافضاً الأخذ بما تدل عليه تلك الروايات مع أنها بالمعايير السندية معتبرة. ويستند في ذلك إلى أنّه لا يعقل أنّ يفعل الإمام المعصوم عليه السلام ذلك، فلو فعله عالم لقلنا عنه الكثير ولاستهجنا منه بل لا نتوقع ذلك من عالم، فتصور أن مرجعاً لديه بستان عنب يبيعه لشركة تعمل من العنب خمراً. يقول الإمام الخميني(قده): فكيف نتصور ذلك من إمام معصوم(ع) مسؤول عن بيان الأحكام بسلوكه قبل أقواله، وعن حماية الدين والمجتمع من أي جرأة أو استهتار.
مثال ثاني: قضية سمرة بن جندب الذّي باع بيتا لشخص من الأنصار لكنه ترك في باحة البيت شجرة، فكان يذهب إلى شجرته من دون أنّ يستأذن على الأنصار مما سبب حرجاً للأنصاري وزوجته. فطلبوا منه أنّ يستأذن فرفض محتجاً بأنّ الشجرة له ولا يحتاج إلى إذن للدخول إلى ملكه. فاشتكاه الأنصاري إلى رسول الله(ص) فعرض عليه الرسول(ص) شجرة في الجنة على أنّ يتنازل عن هذه فرفض، وزاد العرض وكان كلما يزيد الرسول(ص) العرض يرفض، إلى أن قال الرسول(ص) للأنصاري إقلع الشجرة وارمها، ولم يعط ابن جندب مقابلها شيء، وأطلق الرسول(ص) جملته المشهورة: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وشكلت أساساّ لكثير من الأحكام الشرعيّة.
6) ومن الآن وحتى تظهر لنا المنظومة المتكاملة بأسسها وفروعها، علينا أن نبحث هذا البحث عن قيمومة الرجل على المرأة. ولكن ننبّه على أنّ المحاضر عادة يقع تحت تأثير إظهار ما يُقنع المُستمع بينما يجب عليه أنّ يكون في مقام بيان ما يعرفه حقيقة سواء أعجب المستمع ذلك أم لا. والثغرة في هذا الموضوع أنّ المحاضر لم يؤسس لمحاضرته تأسيساً كافياً يقتضي مروراً ولو مختصراً على المنظومة التي أشرنا إليها سابقاً، وأنّ المستمع له قابلياته الخاصة أو آماله الخاصة يتمنى أن يوافق عليه الشرع أو يتمنى تطويع الشرع لها، أو ربما تأثر المحاضر أو المستمع بثقافات عايشها أو اطلع عليها فلاقت هوى في النفس واستحسنها فيسعى بكل قدرته لإثبات موافقة الدين عليها. من الخطورة بمكان تقديم الدين من هذه النظرة فهو أشبه بتشريع من عنادياتنا نلبسه لباس الدين.
وكيفما كان فإنّ الأساس في الموضوع قوله تعالى في الآية 34 من سورة النساء:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾.
هذه آية واحدة تتحدث عن القوامة وعن التعامل مع اللاتي تخافون نشوزهن أي ظهرت عليهن إمارات التمرد لجهة عدم إعطاء الرجل حقوقه. وهذه قضية أخرى شائكة لا نستطيع أيضاً أن ننظر إليها بشكل مستقل عن المنظومة ككل. فمن هو المخاطب بقوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ هل هو رجل ناشز أيضا أم ليس مقصرا في تعامله مع المرأة؟ هل هو رجل سيء المعاملة بحيث جعلها تنفر منه أم هي حسن المعاملة ولم يكن نشوزها إلا ضربا من اللؤم؟ هل نشوز المرأة ثابت بدون خلفية سيئة ولكنها لا تستطيع لسبب من الأسباب أداء بعض حقوقه؟ القضية في الإطار الأوسع ستساعد أكثر على فهم الآية. أذكر هذا استطراداً لأكمل بأنه على أساس تلك المنظومة نفهم كلمة ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ لذا ذكر بعض علمائنا أن الضرب يجب أن لا يتنافى مع العشرة بالمعروف فهو ضرب خفيف جدا كالضرب بالمسواك. كما روي عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام. وبعضهم قال أن الضّرب يكون بمنديل ملفوف. يعني ضرب غير مؤذي. ولا يجوز أن يكون هذا الضرب أمام أحد فهذا هتك وأذى لم تسمح به الآية.
7) من هنا يجب العود إلى المنظومة التي تحدثنا عن ضرورة التعرف عليها وبدونها كل هذا الكلام يصبح هباء لا ضابطة تقيّد تطبيقاته ولا إشراف صحيح على استخدام القوامة. فمع أنّ هذه الآية ذكرت ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ قال في موضع آخر ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. فلا يمكن البحث في مدى هذه القوامة بمعزل عن هذه الآية. وبمعزل عن الروايات الصحيحة الشارحة للآيتين معا.
لا بد من معرفة حقوق كل منهما وبدقة وليس فقط التركيز على حقوق الرجل والتعامل بقلة اهتمام فيما يتعلق بحقوق المرأة. وتحديد الدرجة التي تميز بها الرجال. وهي على ما قاله كثيرون درجة القوامة التي نبحث عنه.
فإذا كان من أهداف القوامة حفظ تماسك الأسرة من الفساد والاضطراب والتمزق باعتبار أنّ أي وحدة اجتماعية لا بد أنّ يكون لها آمر وبين خيار أن يكون الآمر الرجل وخيار أنّ تكون المرأة وخيار الشراكة شرع الله تعالى الدور للمرأة فالشراكة لا أمان لها حتى لو كان الشريكان واجبي وجود. فإنّ كان إعطاء الخيار للرجل لذلك الهدف فلن يسمح الشرع بأنّ تكون باباً لإفسادها واضطرابها وتمزقها، بأكل الحقوق.
لم يقل الله تعالى في الآية: بما فضل الله الرجل على المرأة، بل قال: بما فضل الله بعضهم على بعض أي بما أعطى كلاً منهما من قدرات كان كل منهما أفضل من غيره فيها، فالرجل له استعداد لا تملكه المرأة والمرأة لها استعداد لا يملكه الرجل، وكلا الأمرين اقتضيا رسم تلك العلاقة الأسريّة.
8) كما لا يمكن معالجة القوامة بمعزل عن قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وفي آية أخرى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وللأسف بعضنا "لا بيعرف يمسك بمعروف ولا بيعرف يسرح بإحسان". ولا بمعزل عن قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، ولا بمعزل عن قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.
كيف تكون القوامة على أساس العشرة بالمعروف؟ وكيف تكون القوامة على أساس السكن والمودة والرحمة؟ ليس لنا أن ننسى ذلك حين نبحث في القوامة.
كما لا مجال على الإطلاق للبحث في نجاح القوامة بما يؤدي الهدف منها بمعزل عن حسن اختيار كل من الزوجين لبعضهما. وأن يكون كل منهما راضيا بالآخر وفق المعايير السليمة للرضا لكن الرضا وعدم النفور ركيزة، على أن ينصب إلى خلقه ودينه ويساره النسبي وكفاءته في تحمل مسؤولياته. وكفاءتها وصلاحها.
9) كما يجب البحث، حين تشكيل تلك المنظومة عن دور المرأة في الإسلام فبأي مقدار وسع وبأي مقدار ضيق، وما هو الدور الذي يشجع عليه وما هو الدور الذي يشجع على عدمه إلا لضرورات. لقد ناقش الفقهاء في قضية تولي المرأة للقضاء، ومع أنّي لا أؤيد ذلك لأدلة خاصة ليس هنا محل ذكرها، لكن ذكر بعضهم دليلا على أنّ ليس لها ذلك لأنّ الرجال قوامون على النساء. وهو ما رفضه آخرون لأنّ القوامة يجب أنّ تحدد على أساس ما يرسمه الدين من دور للمرأة، وليست القوامة هي أساس كل أدوارها في الحياة.
لذا لا دخل قطعا للقوامة بما يتعلق بفكر المرأة ومالها وعقلها بل وعملها أنّ اشترطت عليه ذلك لارتباطه بموضوع الخروج من المنزل. فهي ليست تبعا له وليست بلا شخصية أمامه هذا كله تعدّ على مفهوم القوامة الذّي ذكرته الآية.
ومع أنّ الآية عبرت بالرجال قوامون على النساء لكن سياق الآية وما قبلها وما بعدها يعطي أنّ القوامة خاصة بالأسرة لا أن الرجال في المجتمع يمارسون القوامة على النساء. أو أنّ الأخ له القوامة على أخته مثلاً. والتعبير في الآية بالرجال والنساء، لأنّ القوامة ترتبط بما أودعه الله في الرجال والنساء من خصائص خلقية توجب ذلك الدور للرجل في الأسرة وللمرأة دور آخر ربما كان في عين الله تعالى أهم.
فليس عن عبث لم تعط الزهراء عليها السلام أي مقام قيادي مباشر في المجتمع مثل الأئمة(ع) مع أنّها أهل لذلك قطعا فهي معصومة تمتلك كل مقومات القيادة ومع ذلك لم تأخذ هذا الموقع.
10) برأيي أنّ العنوان المطروح غير دقيق: هل القوامة سلطة أم ضرورة اجتماعيّة؟ هي على كل حال سلطة، لكن السلطة على نحوين سلطة أبويّة إشرافيّة وسلطة تحكميّة تعسفيّة. فالسلطة هنا ضرورة اجتماعيّة لكنها أيضاً سلطة كما يحب الله ورسوله.
لذا لن تعني أبداً كلمة "قوامون" أنّ المرأة قاصر مثل القصر والأيتام. إنما احتاج الأيتام إلى قيم وولي لقصورهم لا أنّ كل قيم وولي يكون وليا على قاصر، وإلاّ فولاية الفقيّه وهي القوامة على المجتمع لا تعني أبداً أن أفراد المجتمع قاصرون. كيف يكونون كذلك والولي منهم وليس من كوكب آخر فهل استلم قاصر ولاية على قاصرين؟
فهو المسؤول، هو الراعي، هو المنفق، هو المربي هو الذي يتابع، هو الذي يعطي، هو الذّي يوجه، هو الذي يأمر. فالقوامة سلطة وهي بنفس الوقت ضرورة اجتماعيّة لحماية الأسرة والزوجة والأولاد ليتمكن كل من القيام بدوره. فليست القضيّة هل القوامة سلطة أم ضرورة، هي الاثنان معاً، لا تتيح للرجل أنّ يسيء استخدام تلك السلطة بما ينافي غرضها. هي تكليف وليست تشريفا، هي قيوميّة بالقسط لا بالتعسف، على نسق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾. وفي نفس الوقت لا نستطيع تقزيم القوامة، والتعبير بأنّها نوع إدارة وإشراف ليس تقزيما لها إذ لا قوامة في الإدارة إلاّ إذا كانت إدارة مع صلاحيات يعني سلطة. "يعني ما بتزبط يصير الرجل سكرتير". هذا خارج عن معنى القوامة.
يقول الشيخ الطوسي في المبسوط: قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ يعني أنّهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج. وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.. إلى أنّ يقول الشيخ: فإذا ثبت العشرة بالآية فعلى كل واحد منهما أنّ يكف عما يكرهه صاحبه من قول وفعل، وعلى كلّ واحد منهما أنّ يوفي الحقوق التّي عليه من غير أنّ يحوج صاحبه إلى الاستعانة بغيره، ومرافعته إلى الحاكم ووكلائه، ولا يظهر الكراهية في تأدية حق صاحبه مما هو واجب عليه، بل يؤديه باستبشار وانطلاق وجه وعلى كل واحد منهما إذا تمكن من تأدية ما عليه من الحقوق أنّ لا يماطل صاحبه ولا يؤخر فإنّ ماطله مع قدرة الدفع كان آثما.
والحمدلله رب العالمين


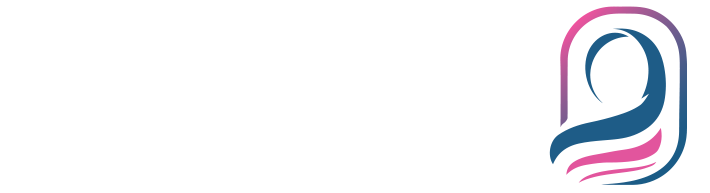





اترك تعليق