
كلمة الدكتور محسن صالح (أستاذ الفلسفة والانتربولوجيا في معهد العلوم الاجتماعيّة): تكامل الأدوار في المنظور الإسلامي للأسرة كبديل حضاري عن طروحات التفكيك والفرداني
تكامل الأدوار في المنظور الإسلامي للأسرة كبديل حضاري عن طروحات التفكيك والفردانيّة في الغرب
كلمة الدكتور محسن صالح (أستاذ الفلسفة والانتربولوجيا في معهد العلوم الاجتماعيّة):
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد موضوعي
يتشابك هذا الموضوع في عناوينه ودلالاته المتشعبة لأنّه يتضمن مصطلحات ومفاهيم غاية في الارتباط الثقافي (الفلسفي/ الاجتماعي). الإسلام كدين عالمي في حضارته التي ينضوي في مرتكزاتها الأسرة وثقافتها وسلوكها التعاقدي، والغرب كجهة جغرافية أخذت بعداً ثقافياً/ سوسيولوجيا، بخاصة الدول العميقة كبريطانيا وفرنسا (الاستعمار الحديث)، والولايات المتحدة الأمريكية كدولة رأسمالية حديثة حاوية لكل العقل الثقافي الغربي، وممثلته من حيث الثقافة والاجتماع والسياسة. لذا، نحن هنا أمام نموذجين تاريخيين ومعاصرين يتنافسان، أو يتصارعان على أن يكونا ثقافة حياة للبشرية جمعاء. هذا الصراع الذي امتد لقرون لا زال يتمظهر في العديد من الأبعاد الحياتية/ الاجتماعية. بدءاً من النظرة إلى الإنسان والحياة انتهاءً بالنظرة إلى الموت وما بعد الحياة. الأبعاد هذه تنعكس على كيفيات تشكل العقل الإسلامي والغربي من حيث النظرة إلى الذات والآخر، الموضوعي والذاتي، الأخلاق والقيم، والخير والشر، الجسد والنفس، الإدراك وموضوعاته وموجوداته، العالم والإنسان، المرأة والرجل والطفل، الأسرة والمجتمع، القوة والسلطة.... إلخ.
نظرة إسلاميّة لمسار تشكل الأسرة:
الأسرة أوّل مؤسسة اجتماعيّة انبنت على نظام تقتضيه مصالح الأفراد الغريزية والطبيعيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والقيم الحتمية اللاحقة على الوجود الطبيعي. والأسرة هي شكل من أشكال الشراكة المبنيّة على الرضى والقبول بين شريكين عاقلين عارفين لطبيعة وغاية هذه الشراكة. من هذه الأسرة التي انطلقت مع أوّل مخلوقين إلهيين هما حوا وآدم، على ما عرفنا عبر التواتر والتاريخ والديانات السماويّة، ومن خلال الأثر الذّي تركاه، تناسلت هذه البشريّة على وجه البسيطة وأضحت ما يربو على 7 مليارات إنسان.
اقتضت الوقائع الحادثة، الضرورية/ الفطرية منها والمكتسبة، الإرادية وغير الإرادية، شكلا" من أشكال التفكير والتدبير، والتعاون الطبيعي والمبتكر، أنّ تتركب البنى الإنسانيّة مع طبيعة وماهيّة الإنسان المخلوق لإله أحسن خلقه وعقله. من هذا التدبير الذي أضحى سنة إلهيّة بديهيّة وسلوكاً إنسانياً ثقافياً وتربوياً نتجت الأسرة/ العائلة/ (صلة الدم والرحم) كمسار طبيعي وفطري وأخلاقي نفسي وتربوي.
مع التطور الذّي أحدثه الإنسان في حياته بفعل العقل والاختراع والاكتشاف انتظمت حياة الأسرة بما ينسجم مع غايات الإنسان وأهدافه ومع الغاية الإلهيّة من هذا الوجود. والأسرة كمؤسسة إنسانيّة أولى تتألف طبيعياً من الرجل والمرأة أولاً ومن ثمّ الأولاد. أوكل أمر تربية وتعليم وتثقيف الأولاد للأهل لما لذلك من أهميّة لا يمكن هجرها من الناحيتين العاطفيّة والماديّة الغريزيّة الوراثيّة: الأب والأم (الحمل والولادة والإرضاع والتغذية). الولد مرتبط بوالدية ارتباط الإنسان بخالقه، شاء أو أبى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(1).
وعلى قدر انتظام الأمر الأسريّ في تنمية الحياة وحركة الوجود الفردي والاجتماعي يصبح التركيب المجتمعي أكثر حصانة من التفكك والانحلال والتمزق النفسي وتعريض العلاقات الاجتماعيّة والثقافيّة للخطر. والانتظام يكون من خلال أن يأخذ كل فرد دوره المناط به بالشكل الذي يحفظ البنية والتركيبة الاجتماعية من أجل دور متكامل يحفظ وجود الجميع بدون بخس لأي من الشركاء المؤسسين. والدور مرتبط بالوظيفة الاجتماعيّة المتضمنة بالتركيب الطبيعي والإمكانات الحاملة لهذا الدور، والتقسيم البنيوي والنفسي، الطبيعي والمكتسب لهذا الدور وهذه الوظيفة. فلا يمكن أن تكون المرأة رجلا ولا العكس ممكنا أيضاً. ولا تسمى أسرة متكاملة إلا إذا عاش كل منهما ما هو (هي) بالفطرة معد له، وهذا ما يمكن أنّ يقال على الأولاد إناثاً وذكوراً، (وخلق الذكر والأنثى). فلو كان بالإمكان أن يأخذ أي منهما دور الآخر لما كان هناك حاجة لخلق جنسين.!
بناءً على ما تقدم فإنّ في طبيعة وجود الأسرة التكامل البديهي لأدوار أفرادها، وإلاّ يصبح النقاش في البديهيات التّي لا تخف على صاحب نظر. فلا إمكانية لتفكير بسعادة أسرويّة إذا كانت الأمور خاضعة لأنانيّة أو لقوة أو لثروة أو لسلطة أحد المشكلين للأسرة. سعادة الأسرة في الإسلام هي في حفظ واحترام أفراد الأسرة كافة، دون بغي أو قهر أو استضعاف.
يقول الإمام السيد علي الخامنئي(دام ظله): "إذا درستم قضية الأسرة في العالم والأزمة التي تعانيها، لرأيتم أن أسباب الأزمة تلك راجعة إلى عدم توازن العلاقة بين الزوجين، بين الرجل والمرأة". المفهوم من التوازن هو أنّ لا تميل الأثقال أو المسؤليات على عاتق الرجل أو المرأة بشكل يسمح بالظلم. أو أن لا يعطى أيّ منهما حقه فيما هو من مهامه، أو أن يستخدم أيّ منهما طاقاته في سبيل اختلال العلاقة لمصلحة طرف ما. هما مسؤولان كل بحسب مهمته لتحصيل السعادة لكليهما ولباقي أفراد الأسرة. أيّ أسر كلّ واحد لمصلحة الكل التوحيدي للأسرة مجتمعة. بهذا تكون الأسرة أول وحدة أو مؤسسة اجتماعيّة/ إنسانيّة. غير ذلك تفرقة وتنافس وخصام وتفسخ. يقول الإمام الخامنئي(دام ظله): "ما من فارق عند الله تعالى بين الرجل والمرأة في طي المراحل والأطوار المعنويّة والتمتع بالحقوق والواجبات الاجتماعيّة والفرديّة، وطبعا فإن لهما حسب الطبيعة الإنسانية امتيازات متباينة."(2) ويقول(دام ظله) "في الإنسانية لا وجود للمرأة والرجل، فالجميع سواسية. هذه هي نظرة الإسلام. لقد جعل الله سبحانه خصائص جسمانية في كل من الجنسين، يكون لها دور في استمرار الخلقة وفي تكامل الإنسان ورقيه وفي حركة التاريخ...(3)". أما مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة الإمام الخميني(قدس سره) فقد رفع المرأة إلى مستوى كلام الله عز وجل من حيث الرسالة والدور والوظيفة حين قال "المرأة كالقرآن كلاهما أوكل إليهما صنع الرجال."
إذن الإسلام لا ينظر إلى الأسرة كرجل وامرأة منفردين كل على حدة. في الأسرة الاجتماعيّة/ الإنسانيّة الرجل والمرأة يتكاملان بعمل مشترك يؤدي إلى صناعة الإنسان خليفة الله على الأرض، والذي يؤدي دوره الرسالي في جعل حياته في مرضاة الله تعالى من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنماذج الإسلاميّة من النساء اللاتي عملن بهذه الروحية السيدة الزهراء عليها سلام الله، والسيدة زينب عليها السلام وأمهات الشهداء في كل المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أمهات الشهداء في كربلاء.
في الآيات القرآنية المجيدة ما يؤكد على عضوية وبنيوية العلاقة الأسريّة بين الرجل والمرأة: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن." إذن لا مندوحة من العلاقة القائمة على حتمية إلهية وطبيعية من أجل اكتمال عناصر الحياة. إن استمرار الوجود الإنساني متعلق بهذه البديهية المفهومية في ما يربط الجنسين، حيث لا استغناء لأحدهما عن الآخر. هي سنة من السنن الإلهيّة الموضوعة في طبيعة الموجودات. وإلاّ ما كان هناك وجود إنساني عبر التاريخ.
صحيح أنّ هناك مشكلات مؤثرة في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلاميّة وما زلنا بحاجة إلى تقويم هذه العلاقة لتترقى إلى درجة أكثر توازنا وتأثيرا مما كانت عليه. إنّ هذا الأمر يحتاج إلى جهود الفقهاء المسلمين والمثقفين، رجالا ونساء، لتقديم تشريعات وتربية تقضي على العناصر الجاهليّة في كل منهما. إلا أنّ التاريخ العربي والإسلامي ما انتقل بعد إلى مرحلة يكون الحكم فيها للدين، حيث لا زالت الثقافة الموروثة التقليدية تعج بالأمثلة والأنماط السلوكية القائمة على مفاهيم غير إسلاميّة تحط من شأن المرأة، أو الرجل. لذلك فإنّ أهمية وضع محددات لبناء أسرة إسلاميّة حديثة قائمة على الدور والوظيفة –في ربط الدنيا بالآخرة- ووصل ذلك بالنماذج التاريخية الفاعلة في مجتمعاتنا، متجاوزين تاريخ السلاطين الذين حكموا باسم الإسلام فشوهوا المعايير والوظائف للرجال والنساء. إنّ أهمية صيرورة الاجتهاد مرتبطة بوضع حلول لمشكلات وظواهر تستفحل في مجتمعاتنا لأنّها إما تعيش إسلام ما قبل الإسلام المقاوم كإسلام حقيقي، أو تستعير "حداثة" الغرب وجندريته في مواضيع الأسرة والتربية ما يخلق تشوشاً واشتباها يزيد في أزمات مجتمعاتنا وتكون الأسرة إحدى ضحاياها.
الغرب والانحراف السوسيولوجي في النظرة للأسرة
لقد قطع الغرب مع الدين كـ "رابطة/ عقد" (اجتماعي/ إلهي) في محطتين أساسيتين من تاريخه. الأولى عندما فك الفرد ارتباطه بالكنيسة، كمؤسسة حامية للدين المسيحي وكعقل حامل للحقيقة الدينية الموصلة إلى خلاص أخروي، وذلك من خلال ما عرف بالثورة البروتستانتية والتي قادها مارتن لوثر في عشرينيات القرن السادس عشر.
أماّ المحطة الثانية فكانت مع الثورة الفرنسية التي ألغت الدين نهائيا من شعاراتها، أو من واجباتها، ورفعت شعار: حرية، إخاء، مساواة. فصل الدين عن الدولة وعن المجتمع، أيّ ما عرف بالعلمانيّة. العلمانيّة التي أرادت إزاحة الكنيسة عن السياسة، نتيجة لعلاقة الكنيسة بأنظمة الحكم التي كانت قائمة، أزاحت في عملية التغيير هذه الدين عن الاجتماع الغربي. المفارقة أن فرنسا الكاثوليكية هي التي قامت بهذا الفعل التاريخي والتغيير الثقافي والسوسيولوجي، ما كانت قد أعلنت تأييدها أو تماهيها مع ثورة مارتن لوثر وكالفن البروتستانتية.
في الحالتين أو الفعلين كان الإنسان الفرد في الغرب عرضة لسلخه وإبعاده عن تعاليم المسيحية التي تقدس الزواج والأسرة. هذه النتائج في الاجتماع الديني والسياسي مهد لواقع اجتماعي غربي انقلابي على القيم القدسية الحاكمة للعلاقات بين الأفراد (المرأة والرجل) والجماعات التي ترعرع عليها المسيحيون والتي تلخص بقول السيد المسيح عليه السلام من أنّ "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان". وهذا الإجراء لا زال يحصل عند أي عقد زواج يتم عبر الكنيسة، وإن كان تحول إلى فولكلور تقليدي، في المجتمعات الغربية. أماّ في الشرق المسيحي فلا تزال آثار الارتباط بالكنيسة المسيحية الأرثوذكسية ماثلة في السلوك الاجتماعي الأسري.
أصبح القانون الوضعي هو الحاكم لعلاقات الناس في الغرب:
هذه الصيغة، أو المنهجية الاجتماعية، حوّلت العقل والقيم الاجتماعية إلى قيم متغيرة تحكمها موازين القوى، بالأحرى القوة. والسلطة والثروة لطالما كانت العنصر الأساسي في تشكل الدول والإخضاع للآخرين. هذا ما كتب فيه فلاسفة الاجتماع والسياسية في الغرب من مكيافيلي (القرن السادس عشر)، هوبز (القرن السابع عشر)، روسو (القرن الثامن عشر)، وصولاً إلى ميشال فوكو (القرن العشرين). خاصة هذا الأخير الذي اعتبر أن القوانين هي صياغة أو صناعة الأقوياء لتسهيل أمرهم في السلطة وإخضاع الآخرين. وكما يقول فوكو فإنه بدلا من فلسفة "إعرف نفسك" السقراطية (نسبة إلى سقراط الحكيم اليوناني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد) تحولت الفلسفة في الغرب المعاصر إلى "إنتبه إلى نفسك" أو "إحم نفسك" أو في العامية العربية "خوذ بالك من نفسك" الفردانية. وهكذا تحول الصراع إلى المتناقضات الاجتماعية الإنسانية غير المحكومة بقيم جماعيّة إلى قيم تقوم على تقديس الفرد، وحريته، وهو الحاكم للقانون وبه. بهذه الروحية، وكنتاج للثورة البروتستانتية، دلفت الرأسمالية إلى العقل الاجتماعي وأضحت هي سيدة الإيديولوجيا الغربية بقيادة الولايات المتحدة. هذه الإيديولوجيا تغنّى بها مُنظّر فلسفة الاجتماع الرأسمالية الأول الألماني ماكس فيبر (توفي في أوائل القرن العشرين) واعتبرها أهم "قيم البروتستانتية" وأعقبه الكاتب الأمريكي من أصل ياباني فرنسيس فوكوياما في كتابه "الإنسان الأخير" الذي كتبه في تسعينات القرن العشرين. في هذا الكتاب يعتبر فوكوياما أنّ الرأسمالية، خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفياتي الشيوعي، هي آخر فلسفة سياسية واجتماعية يمكن للعقل الإنساني أن ينتجها.
رداً على هذه المنطلقات الحاكمة للعقل الغربي، والتّي تهمش المرأة والأسرة وتعتبر أنّ ميزان العلاقة يخضع للثروة والسلطة وليس للإنسان؛ وليس للمؤسسة الاجتماعية الأولى في التاريخ، أيّ الأسرة، حيث يتشارك المرأة والرجل في تركيبها وتشكيلها ورعايتها وقيامتها، نشأت الفلسفة "الجندرية" التي تقوم على التوصيف الفيزيولوجي للعناصر المشكلة للمجتمع الإنساني كأطراف تتصارع على الثروة والسلطة. ليس على أساس تكامل الدور والوظيفة لكل منهما وإنما التنافس والصراع بحسب القدرات التي يمتلكها كل فريق، من ذكر أو أنثى. ومن لديها القوة المشكلة للحكم يحكم وليس المشاركة على أساس أنّ الوظيفة التي يقوم بها الأول لا يستطيع الآخر أنّ يقوم بها. الوصول إلى الهدف بمعزل عن الأصول التّي وضعها العقل الغربي لمن يريد، من يمكنه أنّ يصل، وبمعزل أيضاً عن الأدوات والإمكانات.
نشوء ظواهر غير طبيعية، كالمثليين من الجنسين. تناقص في عدد الولادات والاضطرار إلى التجنيس لرفع معدل نسبة عدد السكان للجيوش والمصانع. غدت الأسر المفككة مزودٌ للطاقة للرأسمالية التي حطمت الحدود التي تقوم عليها الأسرة بارتباطاتها العاطفيّة والعمليّة والتعاونيّة.
___________________
1- سورة الإسراء: الآية23.
2- الشيخ نعيم قاسم، الولي المجدد، ص، 444.
3- الشيخ نعيم قاسم، مصدر نفسه، ص، 447-451


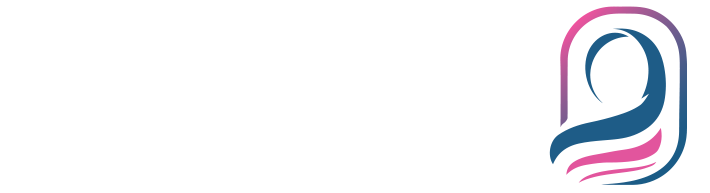





اترك تعليق